طول، عرض وارتفاع: الحزن كجثّة | نصوص

انظري إلى حاكورة البيت هناك، حيث تمطر، تذكّري فناء بيتنا القديم المستأجر. كانت رائحة جدرانه أشبه برائحة الدجاج المذبوح لتوّه، وماذا قلتِ أنتِ؟ جلستِ على الأرض تلعبين. شطفتها بمياه باردة وشطفتك بالمعيّة، مرضتِ لأسبوعين، وماذا قلتِ؟ "أريد فستانًا Pink"، كما علّمتك المتابعة الحزينة للفتيات في الأفراح. أعرف أنّني أحدّثك الآن عن عالم هجرتِه مقابل آلة موسيقيّة تئنّ أكثر من جدّتي، لكنّ الإنسان في الشتاء ليس إلّا كلبًا لمشاعره. هناك، حيث تبلّل الأمطار التراب، شمّرت مشاعري عن رسغيها وراحت تحفر.
تنقّلنا بين خمسة بيوت هذا آخرهم، لا أذكر منهم شيئًا غير بيت الدجاج، المسحة القوطيّة لزوايا غرفه، غرفة الضيوف المليئة بنوافذ يستحيل فتحها والّتي أسميتها غرفة البكاء ولم أبكِ فيها قطّ. كنت أجلس فحسب أحاول استحضار الدموع وتخذلني وحشيّتي. أنا وحشة، في حال نسيتِ ذلك. وهناك، خلف مدفأة الغاز، مددت يديّ مثل أمّ متمرّسة على تدفئة يديها بعد غسل حفنة من الأطباق، وقلت: "أكرهكِ، أكره اليوم الّذي جلبتكِ فيه". أنت فتاة يتيمة، لطالما كنت فاقدة لشيء ما، قسوت عليك. وفكّرت: هذا ما تفعله الوحوش.
ليست لديّ تعويضات، لا يمكن لأيّ شيء أن يكون تعويضًا عن الإنسانيّة، حاولت أن أحبّك وفشلت. كنتِ بنتًا شقيّة، أنفك كبير، لا تجيبين أحدًا حين ينادي عليكِ، تفكّرين كثيرًا وحين تنطقين تقولين أشياءً حمقاء. تحفظين قصائد باللغة الإنجليزيّة، وأنا لا أطيق اللغة الإنجليزيّة، ولا هذا النوع الجريء من الفتيات. الّذي يقول، ويحفظ، ولا يسمع كلام من هم أكبر منه. حاولت قتلكِ نفسيًّا ثمّ باغتتني فكرة أحلى: أن أجنِّدكِ. وإن كان مصطلح كهذا يعيدني إلى اللون الأخضر الزيتيّ والأسلحة الّتي لاحقتني لسنوات في ذاكرتي الهجينة. مزيج من فواصل زمنيّة حاولت القفز بي عن مسرح الأرض إلى مسرح القبور. أولًا كانت الحياة العاديّة ثمّ الانتفاضة ثمّ ما بعد الانتفاضة، هناك، خارج مبنى الذاكرة، حيث يستحيل عليكِ أن تنظري، دفنت الكثير.
شهدت الثلج لمرّة واحدة في حياتي، حين خسرت بيتنا في القدس وصار لزامًا عليّ أن أهاجر إلى كفر عقب. أسمعتِ يومًا بهجرة الحارات؟ كلّا، الأمر لا يشبه استئجار بيت، إنّك لا تطلبين استئجارًا حين تهاجرين، بل تطلبين اعترافًا بأحقّيّتك في الاسئجار، كغريبة. لذا حين يسألك أحد عن تاريخكِ الحافل بالاستئجارات، قولي له إنّك امتلكت يومًا، أو كدت تمتلكين لو لم تهاجري، بيتًا بطابقين، كلّه لكِ. نسيت شكله، لكنّني لم أنس الثلج. واليوم، آكل ذاكرتي كلّ مساء دون فائدة، كيف أقتصّ من الطفلة الّتي في داخلي؟
أنتِ، كان من الأسهل عليّ أن أقتصّ منكِ.
طفح الكيل، لماذا تنظرين إليّ بشرود، تظنّينني حمقاء؟ نعم، كنت حمقاء لزمن طويل، الحماقة بالذات لا تغتال عمرًا بعينه. أمّا السعادة فبلى، تقلّ في الثلاثينات وتموت مطلع الأربعين مثل نبيّ في بداية رسالته. لعلّكِ لا تتّفقين معي، أو هذا على الأقلّ ما يقرّ به تاريخكِ الّذي لم يهاجر من حارة إلى حارة مثلي، بل كان عليه أن يترك على قارعة طريق لعابر السبيل التالي. تقاطعت تواريخنا، من منّا شوّه الآخر؟ ربّما جئنا، كما يقال، مشوّهين من تلقاء أنفسنا، والتاريخ وقف مثل شرطيّ كان على وشك اعتقال أحدهم لكنّه نسي أصفاده. يطالعنا ممسكًا وسطه بكلتا يديه، هامسًا: "كارثة".
والدكِ الّذي تبنّاك، فشل حتّى في تبنّي نفسه، حذاؤه مقشّر أكثر من يديّ أيّام الخريف، مقاساته مثل مقاسات العمالقة، يبدو للناظر من بعيد وكأنّه دُسّ دسًّا في عالمنا الصغير. يستعمر المشاهد كلّها دون استئذان مثل شيخ مسجد وحيد بين سكّان قرية مسيحيّة، يجلس في آخر الصالة ويقول من مئذنته تلك كيف ينبغي لبقيّة المشاهد أن تكون. سأفشي لك سرًّا، المشهد التالي من اختراعي، حين يناديني سأقول: "عذرًا سماحتك، تعقيبًا على ما سلف، لا اعتراض ولكن سيشويك الله بدءًا من مثانتك".
لكنّ الله لا يشوي مثانات الناس ولا أيّ جزء آخر من أجسادهم، أو إن صحّ القول فإنّه يضعهم على قائمة المرشّحين حتّى تثبت إدانتهم. أمّا أنا فلا أصبر على أيّ شيء في هذه الحياة، لا أصبر حتّى على صوت أنفاس الشخص الجالس بجانبي، يخيّل إليّ أنّ الكون محاصر في جوفه، يقفز مثل كرة بحجم انفراجة متوسّطة بين السبابة والإبهام، وهي لعبة كنّا نسلّي أنفسنا بها في صغرنا، نشتريها فقط حين نزور مدينة الألعاب لأنّها تحشر بدورها داخل صندوق شفّاف مع عشرات الكرات، نضع فيه درهمًا وتختار لنا الآلة ’ارتجالًا‘ واحدة ثمّ نتلقّفها، لها اسم هجين من العامّيّة والفصحى لم يعد رائجًا في عصركِ: «الطابة المجنونة». هناك، حيث تتراقص وريقات شجرة الليمون المبتلّة، تقفز حفنة الكرات الّتي جمعتها على امتداد طفولتي، ستعثرين عليها متفرّقة في البيوت الّتي هجرتها.
هنا، أثاثنا الأرض، وهذا الشرخ الطوليّ المصمّم برعاية الزجاج الّذي كان مصقولًا أيّام عزّه، اهترأ الآن، وصار يطالعنا بنظرات مجروحة يسهل تعقّبها حين تضربها أشعّة الشمس. أنتِ لا تعرفين شيئًا عن النظرات المجروحة القادمة من نافذة إلى إنسان، خدوش كان عليها أن تحدث، لا بدّ أن تحدث لأنّها في مفهوم التكلّسات الزمنيّة للأدوات الفانية ليست إلّا تحصيل حاصل.
حين تشرق الشمس سأقف هنا، أمامها، وسأخبرك بعمر النافذة الافتراضيّ، لكنّني أقول - وعلى نحو مبدئيّ: "إنّها من جيل شقيقتي سامية، بين الثلاثين والأربعين. الفارق الوحيد بينها وبين ساميتنا هو أنّ النافذة ظلّت حيّة رغم جراحها".
أنا ’شبحة‘ مؤنّثة. وعلى سيرة ’الشبوح‘ بجمعها نادر الاستخدام: أسمعتِ يومًا بالعنف اللغويّ؟ خبرته عام 1993، حين صار لزامًا عليّ أن أسمّي أشياء كثيرة بغير مسمّياتها، أحيانًا كنت أثور على التعنيف الممنهَج للّغة، لغتنا، وأقول إنّ ما حدث ليس إلّا اتّفاقًا، فيه ثلاثة كلمات هي الأكثر رواجًا: طاولة، ورقة وقلم. فهل يعقل أن يصير الجماد فاعلًا ينبش عوالم الذاكرة بتحفيزات من المرارة والخداع، ألا يمكنني أن أفكّر بشكل سويّ في طاولة بيتنا المفروشة بملاءة تغطّيها أزهار سوسن متفتّحة على نحو مثير للغثيان؟
ملاءة قليلة حظّ وسقيمة، خسرت لونها إثر مسح أمّي لسطحها بعد كلّ وجبة، كما أنّ قطّتنا سميرة لاحقت أطرافها المتدلّيّة وأشبعتها جروحًا. لا أعرف في أيّ بيت كانت لدينا هذه الطاولة، أمّا الملاءة فتكبرني بعشرين عامًا ومصدرها مجهول.
أنتِ تستخدمين كلمات إنجليزيّة، ترجمي لنا ما يقولونه باعتياديّة وبلسان صقلته الاختصارات: ’جدار عازل‘ بدلًا من ’جدار الفصل العنصريّ‘، ’تنسيق أمنيّ‘ بدلًا من ’السلطة الفلسطينيّة تساعد على تسليم أبناء الوطن للاحتلال‘، ’أوسلو‘ بدلًا من ’اتّفاقيّة الاعتراف بالكيان الإسرائيليّ وسلطته على الأرض والشعب‘، ’منطقة أ، ب، ج‘ بدلًا من ’فلسطين التاريخيّة‘. ترجمي لنا المصطلحات الّتي تهاجر عبر الشقوق مثل خلد لغويّ يفسد حقولنا كي نظلّ نستبدلها بمصطلحات أخرى تتماشى مع تصحّرنا المعرفيّ. وهناك، في البقعة العمياء من الدماغ، حيث تنمو الكلمات ويعاد تدويرها، ستكتشفين أنّ معظمنا يعيش دون أدنى إحساس بأيّة لثغات فكريّة.
أتعرفين؟ لقد أمرضني الزمان وأفقدني بصيرتي. إنّ الجدار وإن حُكِيَ بالإيرلنديّة يظلّ جدارًا قائمًا في الروح، حتّى يخيّل إليّ أنّي إذا سمعته ولم أفكّر في جدارنا هذا، فإنّ قيامة ذاكرتي ستقوم ملاحقة خلاياي الحسّيّة بسرب من الألواح الإسمنتيّة المتخيّلة، ألواح متّسخة تقطر منها الألوان والأقمشة وكأنّها اقتُلِعَت من القدس وجاءت إلى رأسي. نعم، لطالما كانت هذه الألواح بريدنا المجروح إلى الأحبّة، أمّا الأقمشة فما هي إلّا بقايا كنزات قديمة لمحاربين عزّل، باتت انتصارًا عالقًا بين فكَيّ أسلاك صدئة، تحرّكها الرياح مثل أعلام غير معترف بها. وهناك، حيث ترفرف الألوان والأقمشة خارج الزمن المأهول، ستجدين بصيرتي.
لماذا تتثاءبين، لأنّني ما عدت أحكي عنكِ؟ أنتِ جاهلة، أحيانًا أحسدكِ على جهلكِ، أتمنّى لو كان في استطاعتي شراء الجهل من بائع التبغ في الكشك المقابل لـ «البنك العربيّ». أن أصرِفَ معرفتي، كلّها. أن أنظر إلى الجدار نظرة الغريب الّذي لم يفقد كنزته هناك، ولم ينقل شقيقته مع الشبان إلى مجمّع رام الله الطبيّ، ولم يشهد أيّ عنف صوتيّ بين المكانين: جدار الثورة والانتفاضة، ومشفى الموت والخرس البشريّ. على حذائي دماء، ليست لي، ويحزنني، أو كان قد أحزنني سلفًا أنّها ليست دمائي. وأنتِ كنتِ هناك، وماذا قلتِ؟
أريد العودة إلى البيت، تعبت من الركض يا حقيرة.
وكنت حقيرة فعلًا للمرّة الأولى في حياتي، لأنّني أجرّ شقيقتي وأتخيّلني حاملة أعوامها الثلاثين مثل حزم من الخطوط القصيرة الّتي اعتدنا رسمها على اللّوح في درس الرياضيّات أيّام الابتدائيّة، تتساقط منّي تباعًا: عشرات، آحاد وبضع كسور. هناك، حيث أمسكت بقلب سامية المثقوب ونُزِعتُ من المشهد بفضل قفّاز طبيّ محشوّ بيد بشريّة تفتقر إلى المهنيّة، أضعت طفولتي وهجرت البكاء.
صرت ربّة الصمت في بيت ليس من حقّي دقّ مسمار على جداره لتثبيت وجه سامية. ليست لغة الاستعمار وحدها الّتي تغيّر وتحتقر. لماذا لا تقرئين الشروط أسفل كلّ عقد استئجار؟ لأنّك موسيقيّة لعينة، كلّ ما تريدينه هو مساحة صغيرة تستوعب مبيت الكمان في زاوية آمنة طوال الليل. وليتك تجيدين العزف ’من القلب‘ كما يقال.
لذا لا يحقّ لك الاعتراض، على ذاكرتي، أحبّائي ولغتي. لأنّني لست مثلك، لديّ ما يدعو الآخرين إلى احترام وحشيّتي. أمّا أنت فعديمة الإحساس، أقصى ما بوسعك تقديمه هو مقطوعة تدرّبت على عزفها لساعات.
أخذنا الوقت ومرّت ساعة الغداء دون أن نأكل فيها شيئًا غير أنفسنا. ربّما العودة المفاجئة إلى هذا المكان هي السبب. سبع ’رصاصات مطّاطيّة‘ مرصوفة بإتقان تحت لوح إسمنتيّ مثقوب صبغته دماء شقيقتي تطوّعًا بلون قرمزيّ فشل الزمان في كنس حمرته، سبع رصاصات يتراقصن على أوراق شجرة الليمون المطلّة على بيتنا المستأجر الأوّل، أراها الآن أمامي. سبع كرات حصيلة هجرة الحارات، يتقافزن في رأسي. وماذا تقولين أنتِ؟
صداع نصفيّ، من يحتمل هذه الموشّحات كلّها دون وجبة ولو خفيفة؟
أنتِ على حق، لقد مضى زمني، ليس من حقّي أن أُسْمَع الآن وقد سكتّ طوال هذه السنوات. لكن، أتعرفين؟ لا أحسدهم، أولئك الّذين يسكنون داخل غرفة بجدران أربعة وسقف كلّها لهم، يمتلكون بيوتًا في كلّ مكان، في المدن، في القرى، بين أشجار اللوز وقبالة المستوطنات. لا أحسدهم على ألقابهم غير المقرونة بالاستئجار، لأنّ أرواحهم بيعت منذ زمن طويل إلى غرباء لا يضحكون.
أتمنّى أن أستعيد زمن ’الطابة المجنونة‘، أتمنّى أن أضربها إلى الجدار فتعود إليّ، أتمنّى أن أستعيد ولو جدارًا واحدًا فقط من بيتنا في القدس، أستضيف عليه وجه سامية الّتي أصيبت كلّ صورها بالربو من المكوث الطويل تحت الأسرّة. أتمنّى أن أضرب الرصاصة المطّاطية فتصيبك أيّتها الجثّة. أتمنّى أن أنتقم منكِ، لكنّ الناس لا يفهمون، ماذا سيقولون؟ تمامًا كما كنتِ ستقولين: هناك، عند الجدار، حيث استشهدت شقيقتها، انتحرت هي من ترف الحزن.
لا أحد سواكِ يعرف، أنّني عشت حياتي أحملكِ جثّة خزّنت طولها وعرضها وارتفاعها كلّه منذ ميلادي، لتبصقه قبالتي اليوم، جدارًا يفصل سعادة الدنيا كلّها عن حزني. اطمئنّي أيّتها الموسيقيّة الراحلة، لقد كشفت لعبتكِ: لن أخربش عليه. سأهدمه.
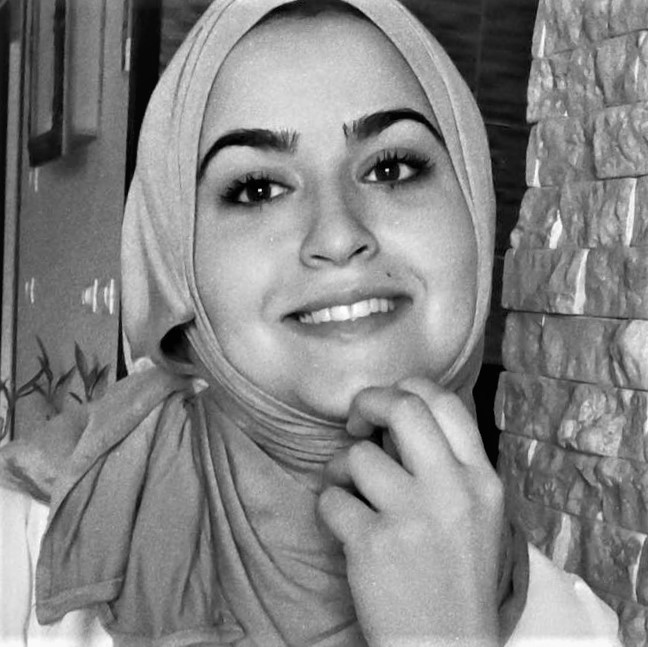
كاتبة فلسطينيّة من مواليد مدينة بيت لحم عام 1999، دَرَسَتْ «الإعلام» في «جامعة بير زيت»، وصدرت لها عدّة روايات، وتكتب في عدد من المنابر الإعلاميّة الفلسطينيّة والعربيّة.







